تقرير التفقد البيداغوجي في تونس بين الرقابة البيروقراطية والوظيفة التكوينية: قراءة نقدية في ضوء القانون المدرسي لسنة 1964
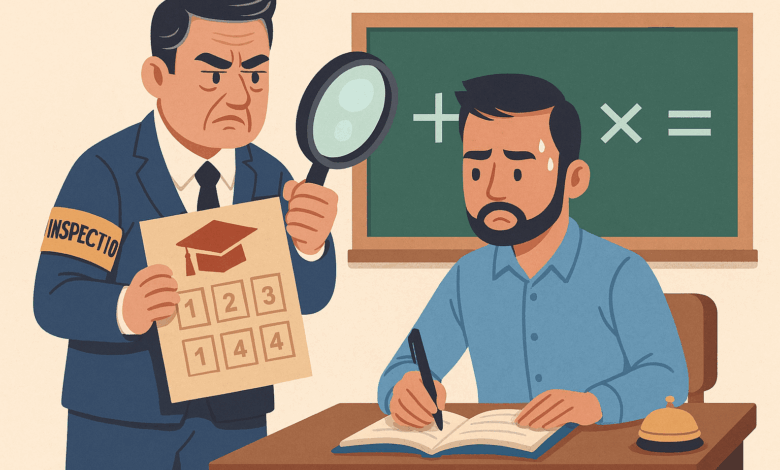
المقدّمة
تُعدّ منظومة التفقد التربوي في تونس من أبرز آليات ضمان الجودة في التعليم الابتدائي، إذ تهدف نظريًا إلى تقويم الأداء المهني للمعلمين ومرافقتهم في تطوير ممارساتهم البيداغوجية. غير أنّ الممارسة الواقعية، كما تُترجمها النماذج الرسمية لتقرير التفقد، تكشف عن تحوّلٍ جوهري في وظيفة التفقد: من أداة تكوين وتطوير إلى آلية رقابة إدارية ذات طابع تقويمي كمي جامد، تُفرغ الفعل التربوي من محتواه الإنساني والقيمي.
ولعلّ العودة إلى القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964، بوصفه المرجع التشريعي الأقدم والأكثر استحضارًا في السياق الإداري التربوي، تتيح قراءة نقدية دقيقة للمفارقات بين النصّ القانوني الأصلي ومقتضيات التقرير المعمول به اليوم.
أولًا: في المشروعية القانونية وحدود التكليف المهني
تفصيل في الإطار القانوني المنظّم لواجبات المعلم
يُعدّ الفصل 45 من القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 نصًّا تأسيسيًا في تحديد علاقة المعلّم بالوثائق القانونية الملزمة له داخل المؤسسة التربوية. فقد نصّ بوضوح على أن من واجبات المعلم:
«إمساك دفتر المناداة، ودفتر الإعداد الشهري، ودفتر بيان الدروس اليومية طبق الأنموذج المقرّر».
إنّ هذه الصياغة الدقيقة لم تأتِ اعتباطًا، بل جاءت ثمرة تصوّر تشريعي واضح للوظيفة التعليمية آنذاك، حيث كان يُنظر إلى المعلّم باعتباره مُنفّذًا للبرامج الرسمية ومتابعًا لمستوى التحصيل داخل القسم، لا موظفًا إداريًا مثقلًا بالوثائق الثانوية.
فدفتر المناداة يمثل السند الإداري الأساسي لضبط حضور التلامذة، ودفتر الإعداد الشهري ودفتر الدروس اليومية يمثلان الأداة البيداغوجية لمتابعة سير التعلّم.
وبذلك، يتحدد نطاق التزام المعلّم في حدود معقولة تحفظ التوازن بين الجانب الإداري والتنفيذي دون إفراط أو تحميل زائد.
أما الفصل 13 من القانون ذاته، فقد وسّع دائرة الواجب البيداغوجي دون الخروج عن هذا المنطق، إذ أوجب على المعلّم اعتماد كراس دوري يتداوله التلامذة (كراس التناوب)، غايته التربوية مزدوجة:
- تمكين الإدارة التربوية من مراقبة التسلسل البيداغوجي للتمارين الكتابية، أي انتظام سير الدروس وتدرّجها الزمني والمنهجي.
- تمكين المعلّم والمتفقد من ملاحظة التطوّر في مستوى المتعلمين عبر إنتاجاتهم اليومية، وهو بذلك وسيلة تقييم غير مباشرة لا مجرّد وثيقة شكلية.
إنّ هذا البناء القانوني يُبرز روحًا تشريعية متوازنة، تعتبر الوثيقة وسيلةً لخدمة الفعل التربوي، لا غايةً في ذاتها. غير أنّ الممارسة الإدارية الحديثة — كما تكشفها نماذج تقارير التفقد — انزلقت بعيدًا عن هذه الفلسفة، فتحوّل ما كان أداةً تربوية إلى عبء إداري بيروقراطي يتكاثر فيه الورق وتضيع فيه الرسالة.
تجاوزات تقرير التفقد ومبدأ الشرعية الإدارية
يُدرج التقرير التربوي المعتمد اليوم مجموعة من البنود غير المنصوص عليها قانونًا، إذ يُلزم المعلم بـ:
- إعداد كراسات القسم التي لم ترد في أي فصل من القانون المدرسي.
- إعداد المعلّقات الرسمية (جداول الأوقات، التوزيعات السنوية والشهرية، القائمات الاسمية…)، وهي عناصر وردت فقط في مشروع تنقيح سنة 1986 الذي لم يُصادق عليه رسميًا.
- مسك بطاقات المتعلمين ودفاتر المراسلة التي تندرج ضمن صلاحيات الإدارة أو المساعدين الإداريين، لا ضمن واجبات التدريس.
بهذه الإضافات، يتحوّل التقرير من وثيقة تقويمية إلى أداة تحميل إداري غير مشروع، تُحمّل المعلّم ما لا يلزمه به القانون، وتُقيم أداءه بناءً على أعمال لم تُحدَّد بمرسوم ولا أمر حكومي.
من زاوية القانون الإداري، يُعدّ هذا الوضع خرقًا واضحًا لمبدأ الشرعية (Principe de légalité)، وهو أحد الركائز الأساسية في تسيير المرافق العمومية.
فلا يجوز لأي سلطة تنفيذية — مهما كانت رتبتها — أن تُنشئ التزامًا جديدًا أو واجبًا مهنيًا لم يَرِد في نص تشريعي نافذ، إذ يُعتبر ذلك تجاوزًا للسلطة (Excès de pouvoir).
وإذا كان القانون هو الإطار الأعلى الذي يحدد الحقوق والواجبات، فإنّ كلّ منشور أو مذكّرة داخلية تُضيف إلى هذا الإطار تعدّيًا على التسلسل الهرمي للنصوص، ومساسًا بمبدأ الأمن القانوني للموظف العمومي.
البعد الأخلاقي والإداري للمسألة
إنّ هذا التجاوز لا يقتصر على الخلل الشكلي في النصوص، بل ينعكس على العدالة المهنية داخل المؤسسات التربوية.
فالمعلّم الذي يُقيَّم بناءً على وثائق غير مقرّرة قانونًا يجد نفسه في موضع مساءلة غير شرعية، ويُحمَّل مسؤولية “نقائص” لم تُدرج ضمن مهامه الأصلية.
وبذلك، يصبح تقرير التفقد — في جوهره — ممارسة تأديبية مضمرة لا تقويمية، حيث يُستعمل التقييم لتكريس السلطة الإدارية لا لتطوير الممارسة التربوية.
ومن منظور أخلاقي، فإنّ تقييم الموظف على أساس معايير غامضة أو غير قانونية يُعدّ مسًّا بمبدأ العدالة الإدارية والإنصاف الوظيفي، ويؤثر سلبًا على المناخ المهني، إذ يولّد شعورًا بالغبن وفقدان الثقة في المؤسسة.
إنّ التناقض الصارخ بين روح القانون المدرسي لسنة 1964 وما يطبَّق فعليًا في الممارسة الرقابية اليوم، يكشف عن أزمة أعمق في المنظومة التربوية:
أزمة غياب المرجعية القانونية الموحّدة، وتغوّل الاجتهاد الإداري على حساب التشريع التربوي.
ولذلك، فإنّ أيّ إصلاح حقيقي للتفقد يجب أن يبدأ بإعادة تأصيل التقييم في نصوص قانونية حديثة وواضحة، تحترم مبدأ الشرعية، وتعيد تعريف دور المعلم وفق فلسفة التعليم الحديثة التي تجعل منه فاعلًا بيداغوجيًا لا موظفًا إداريًا.
ثانيًا: اختزال العملية التربوية في نموذج تقييمي رقمي
يُلاحظ أنّ تقرير التفقد التربوي كما هو معمول به حاليًا، يعتمد على مقاربة كمية صرفة في تقويم الأداء، حيث تُختزل العملية التعليمية-التعلّمية في شبكة من المؤشرات الرقمية تتراوح من (1 إلى 4)، وكأنّ الإبداع البيداغوجي قابل للقياس بمعادلة حسابية دقيقة.
بهذا الاختزال، يُفرغ التقييم من بعده التكويني والإنساني، ويتحوّل إلى ترقيم بيروقراطي جامد يختزل المعلم في خانة رقمية، ويُحوّل العملية التربوية إلى ملفّ إداري أكثر منها فعلًا معرفيًا تفاعليًا.
إنّ هذه المقاربة لا تقيس التحوّل النوعي الذي يُحدثه المعلّم في عقول المتعلمين، ولا تُلامس أثره في تشكيل شخصياتهم ومهاراتهم، بل تكتفي بقياس مخرجات شكلية لا تعكس جوهر الممارسة التربوية. فالمعلّم الذي يُحفّز المتعلم على طرح الأسئلة والشكّ الخلّاق لا يُقدَّر في هذا النظام أكثر من المعلّم الذي يكرّر الدرس بحذافيره. وهنا تكمن المفارقة: يُكافأ الانضباط الإجرائي، ويُهمل الإبداع التربوي.
منطق الكمّ في مواجهة منطق الكيف
تقوم الفلسفة التربوية الحديثة — منذ أعمال “بلوم” و”برونر” و”بياجيه” — على أنّ التعلّم لا يُقاس فقط بما يُنجز، بل بما يُغيّر في بنية التفكير.
لكن التقويم الرقمي القائم في تقرير التفقد يبتعد عن هذا المنظور الكيفي، ويغرق في ثقافة الكمّ التي تُعلي من الدقة الشكلية على حساب الفاعلية التعليمية.
فبدل أن يسعى المتفقد إلى فهم “كيف يُعلّم المعلّم؟” و“ما الأثر الذي يخلّفه فعله التربوي؟”، ينشغل بتحديد إن كان المعلم قد “نوّع الوسائل” أو “احترم الزمن البيداغوجي”، وفق خانات معدّة سلفًا، لا تتسع للفكر النقدي ولا للابتكار.
هذه النزعة الكمّية التقويمية، وإن بدت علمية في ظاهرها، تُخفي وراءها رؤية تكنوقراطية للتعليم، ترى في المدرسة جهاز إنتاج لا فضاء بناء للذات الإنسانية. إنها تحوّل المعلّم إلى عامل ينفّذ خططًا مرقّمة بدل أن يكون مبدعًا في بناء التجارب التعلّمية الحيّة.
غياب البعد النوعي في قراءة الفعل التربوي
الفعل التربوي، في جوهره، ظاهرة كيفيّة مركّبة لا تُختزل في أرقام أو مؤشرات جاهزة، لأنّها تتعلّق بالكائن الإنساني في بعديه العقلي والوجداني.
فالدرس ليس مجرّد “سيناريو بيداغوجي” محكم الصياغة، بل هو تفاعل حيّ بين معلّم ومتعلّم وسياق.
ولذلك فإنّ تقييمه يستوجب أدوات تحليل نوعية: الملاحظة الميدانية الدقيقة، المقابلة التأملية، تحليل التعلمات المنجزة، وتتبع التطور المعرفي والسلوكي عبر الزمن.
غير أنّ التقرير الحالي يُقصي هذه الآليات التحليلية الدقيقة، ويستبدلها بنظام “الاستمارة الموحّدة” الذي يقتل خصوصية القسم والبيئة التربوية.
فمدرّس في ريف فقير يُقيَّم بالمنطق نفسه الذي يُطبّق على زميله في مدرسة نموذجية بالعاصمة، دون اعتبار الفوارق السياقية والمادية والثقافية.
وهذا ما يجعل التقويم في جوهره مجرّد مقاربة شكلية فاقدة للعدالة التربوية.
آثار النموذج الرقمي على الممارسة المهنية
إنّ اعتماد التقويم الرقمي المجرّد أفرز نتائج سلبية متعدّدة، أهمّها:
- توحيد الأنماط التعليمية: حيث يسعى المعلّم إلى تقليد النموذج المثالي الذي يرضي المتفقد، لا إلى بناء منهجيته الخاصة.
- ضعف روح المبادرة: إذ يتجنّب المعلّم التجريب خشية أن يُساء تأويله في التقييم.
- انحراف التقييم عن غايته التكوينية: فبدل أن يكون مناسبة للتغذية الراجعة والنمو المهني، أصبح لحظة محاسبة ومفاضلة.
- إضعاف الدافعية المهنية: لأنّ الجهد الإبداعي لا يجد اعترافًا موضوعيًا ضمن نظام يعتمد الأرقام لا الأفكار.
هذه النتائج تُفضي إلى ما يمكن تسميته بـ “أزمة الثقة التربوية”، حيث يفقد المعلم الإحساس بالعدالة في التقييم، ويغدو اهتمامه مُنصبًا على النجاة الإدارية لا على الإتقان التربوي.
نحو مقاربة تقييمية بديلة
لا يمكن إصلاح هذا الخلل إلا عبر تبنّي نموذج تقييم كيفي-تكويني يقوم على المرافقة والتحليل لا على التصنيف.
إنّ التقويم التربوي الحديث يقتضي:
- بناء أدوات تحليل نوعي تُبرز أثر المعلّم في المتعلم، لا أثر الوثائق في المتفقد.
- اعتماد ملفات مهنية مفتوحة (Portfolios) تُمكّن المعلّم من توثيق تطوّره الذاتي بدل حصره في رقم.
- تعزيز ثقافة الحوار التأملي بين المتفقد والمعلم، حيث يصبح التقرير خلاصة نقاش مهني لا حكمًا إداريًا.
- إدماج المؤشرات السياقية (البيئة الاجتماعية، حجم القسم، الموارد، الفوارق الجغرافية) في تحليل الأداء.
إنّ التحوّل من التقييم الرقمي إلى التقييم التأملي ليس مسألة تقنية، بل هو تحوّل فلسفي في نظرة الدولة إلى المعلم:
من أداة تنفيذ إلى فاعل فكري، ومن رقم في منظومة إلى شخصية تربوية تحمل مشروعًا معرفيًا وإنسانيًا.
ثالثًا: الأزمة البيداغوجية في العلاقة بين المتفقد والمعلم
من المفترض، في فلسفة التفقد التربوي الحديثة، أن تقوم العلاقة بين المتفقد والمعلم على التكامل لا التسلط، وعلى المرافقة لا المراقبة، وعلى التمكين لا التقييم السلطوي. فالمتفقد، في تصوّره الأصلي، ليس قاضيًا يُصدر أحكامًا ولا مراقبًا يسجّل النقائص، بل هو مرشد بيداغوجي يرافق المعلّم في رحلته المهنية، ويعينه على تجاوز الصعوبات وتحسين أدائه ضمن مناخ من الثقة والمسؤولية المشتركة.
غير أنّ التقرير المعمول به اليوم — بما يحمله من بنية لغوية وأسلوبية ومضمونية — يعكس تحوّلًا خطيرًا في طبيعة هذه العلاقة. فبدل أن يكون التفقد ممارسة تشاركية قائمة على الحوار والتغذية الراجعة (Feedback Constructif)، صار يُمارَس بمنطق التفوق الهرمي والرقابة البيروقراطية، فيتحول الفعل التربوي إلى مسرح للهيمنة الإدارية، لا لارتقاء الوعي المهني.
من التفقد البيداغوجي إلى التفقد السلطوي
تنبع هذه الأزمة من انزياح المفهوم الأصلي للتفقد من مجاله التربوي إلى مجال الضبط الإداري. فقد أضحى المتفقد في المخيال المهني رمزًا للرهبة لا للثقة، وارتبط اسمه بـ”الزيارة الفجئية” و”التقرير الحاسم” و”النقطة الترتيبية”، أكثر من ارتباطه بالدعم والتوجيه.
فما إن يُعلن عن قدوم المتفقد حتى يسود في المدرسة نوع من الاستنفار العام، يُعاد فيه ترتيب الفضاء وتجميل الواقع، لا استعدادًا للتعلم بل للتحصين من الملاحظة. وهكذا تُختزل ممارسات المعلمين في لحظة تمثيلية قصيرة تُقدَّم أمام المتفقد، في حين تُلغى حقيقة الممارسة اليومية المتواصلة.
إنّ هذا التحول يفرغ التفقد من جوهره الإصلاحي ويحوّله إلى طقس إداري ذي بعد سلطوي، حيث يغدو الخوف من التقييم أقوى من الرغبة في التطوير، ويفقد المعلم إحساسه بالحرية التربوية، فينصرف إلى ما يرضي السلطة التفقدية بدل ما يخدم المتعلم.
اللغة كمرآة للفكر السلطوي
اللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، بل هي انعكاس للبنية الفكرية التي تحكم الممارسة. لذلك فإنّ لغة تقرير التفقد — بما تحمله من أفعال أمرية جافة من قبيل: “يوظف، ينوّع، يؤمّن، يحترم، يلتزم، يكيّف…” — تعبّر عن ذهنية أحادية ترى في المعلّم موضوعًا خاضعًا للتقييم، لا ذاتًا مفكرة ومنتجة للمعرفة.
إنها لغة الوصاية الإدارية التي لا تُفسح للمربّي مساحة للتأمل والمبادرة، بل تحصره في تنفيذ ما يُطلب منه حرفيًا.
من الناحية النفسية، تؤدي هذه اللغة إلى انكسار في الشعور بالاعتراف المهني. فالمعلّم الذي يُقيَّم بتلك العبارات المعيارية يشعر بأن جهده الإبداعي لا يُقاس ولا يُعترف به، وأن ما يُنتظر منه هو الخضوع للنموذج المثالي المرسوم سلفًا لا تطوير تجربته الخاصة.
وهكذا تتحوّل العلاقة بين المتفقد والمعلم إلى علاقة غير متكافئة: سلطة تُصدر وتراقب، وطرف ينفّذ ويتوجّس.
إنّ غياب الحوار التأملي في جلسات التفقد يجعل العملية التقييمية أحادية الاتجاه، حيث يكتب المتفقد ويوقّع المعلم دون نقاش حقيقي حول الأداء أو الأهداف أو الصعوبات.
فبدل أن تكون جلسة ما بعد الملاحظة فرصة للتفاعل المهني، تتحول إلى محضر سماع إداري تُبلّغ فيه الأحكام من طرف واحد، فيغيب النقاش البنّاء الذي يُفترض أن يكون لبّ العملية التكوينية.
إنّ هذه الوضعية تخلق حالة من الاحتراز النفسي داخل الوسط التربوي:
- المعلم يخشى المتفقد أكثر مما ينتظر دعمه.
- المتفقد ينظر إلى المعلم بعين الشكّ أكثر من عين الثقة.
- والإدارة تستغل التقرير كسلاح إداري أكثر منه كأداة نمو مهني.
في هذا السياق، تفقد العلاقة بين الطرفين بُعدها البيداغوجي القائم على الثقة والتعاون، وتتحول إلى علاقة رقابة وتبعية، بما ينعكس سلبًا على جودة الممارسة الصفية وعلى المناخ المهني داخل المدرسة.
في الحاجة إلى ميثاق جديد للعلاقة المهنية
لعلّ هذه الأزمة تطرح ضرورة وضع ميثاق وطني للعلاقة بين المتفقد والمعلم، يحدّد بوضوح طبيعة الأدوار وحدودها، ويكرّس مبادئ التعاون والتقييم البنّاء بدل الرقابة الأحادية.
فالمتفقد في الفكر التربوي المعاصر ليس حارسًا على التطبيق، بل محرّكًا للتجديد التربوي، مهمته دعم التفكير النقدي لدى المدرسين ومساعدتهم على تطوير كفاءاتهم المهنية.
ومن دون هذه النقلة المفاهيمية، سيظل التفقد ممارسة من الماضي، تُعيد إنتاج السلطة لا بناء المعرفة.
إنّ إصلاح العلاقة بين المتفقد والمعلم هو الشرط الأول لإصلاح المدرسة التونسية، لأنّ الثقة المهنية هي أساس كلّ عملية تعلم ناجحة، ولأنّ التربية لا تُبنى بالخوف، بل بالحوار.
رابعًا: تضارب الاختصاصات وتداخل الأدوار
من أخطر مظاهر الارتباك الإداري والبيداغوجي في المنظومة التربوية التونسية ما تكشفه التقارير التفقدية من نزعة نحو توسيع صلاحيات المتفقد وتضييق مهام المعلم، بحيث يُحمَّل هذا الأخير مسؤوليات لا تندرج ضمن مشمولاته القانونية كما حدّدها قانون 25 جانفي 1964 ولا ضمن دوره البيداغوجي الطبيعي كفاعل في عملية التعلم.
فبدل أن يُقيَّم المعلم على كفاءته في إدارة التعلم، وعلى أثره في تكوين المتعلمين، يُخضع التقرير أداءه لمعايير إدارية وتنظيمية لا تمتّ بصلة مباشرة إلى جوهر المهنة التربوية. وهكذا يتّسع نطاق التقييم ليشمل مهامًا من قبيل:
- إعداد البطاقات الإدارية وبطاقات المتعلمين،
- مسك دفاتر المراسلة ومتابعة الغيابات،
- تنظيم الوثائق الرسمية والمعلّقات،
- مراقبة التلاميذ أثناء الراحة أو المغادرة،
وهي مهام تُسند قانونًا إلى مدير المدرسة والقيم والعامل الإداري، لا إلى المعلّم الذي يفترض فيه أن يتفرغ للفعل التعليمي والبيداغوجي.
الخلفية القانونية والخلل في المشروعية
تُعتبر هذه الممارسات تجاوزًا صريحًا لمبدأ تحديد الصلاحيات الوظيفية الذي تقوم عليه الإدارة العمومية الحديثة.
فالقانون المدرسي لسنة 1964، وهو المرجع التشريعي الوحيد المصادق عليه، قد حصر واجبات المعلم في الإمساك بالوثائق البيداغوجية الثلاث (دفتر المناداة، دفتر الإعداد، دفتر بيان الدروس اليومية)، وأشار إلى كراس التناوب كوسيلة تربوية لتتبع المسار التعلمي، دون أن يكلّفه بأي مهام إدارية أو رقابية.
وحتى مشروع تنقيح سنة 1986، رغم ما تضمّنه من إضافات تنظيمية، لم يصدر في شكل قانون نافذ، وبالتالي لا يمكن أن يُستند إليه لتوسيع واجبات المعلّم أو لتبرير ممارسات إدارية جديدة.
إنّ ما يحصل اليوم هو تداخل غير مشروع بين المستويين التشريعي والتنفيذي: حيث تُفرض على المعلم واجبات منبثقة من مناشير أو تقارير داخلية غير مصادق عليها، ما يشكّل من منظور القانون الإداري تعدّيًا على مبدأ الشرعية (Principe de légalité) وخللًا في الهرم النظامي للنصوص.
فالقاعدة في الوظيفة العمومية أنّ المسؤوليات تُحدَّد بالنصّ، لا بالعرف الإداري، وأيّ تقييم يُبنى على واجبات لم تُقرّ تشريعيًا يُعدّ تقييمًا فاقدًا للمشروعية، ويعرّض صاحبه — أي المتفقد — لتجاوز السلطة.
تآكل الدور البيداغوجي للمعلّم
إنّ تضارب الأدوار بين المعلّم والمدير والمتفقد يُنتج ما يمكن تسميته بـ تآكل الوظيفة البيداغوجية للمعلّم.
فحين يُغرق في الأعمال الإدارية الثانوية، يفقد التركيز على جوهر مهمته: بناء المواقف التعليمية، دعم التفكير النقدي، وتحسين الممارسات الصفية.
فيتحوّل القسم إلى فضاء إنجاز وثائق لا فضاء تعلم حيّ، ويغدو همّ المعلم أن يرضي التقييمات الشكلية لا أن يرقى بعمق العملية التربوية.
وهذا الخلل لا يضرّ بالمعلم وحده، بل ينعكس على المتعلم مباشرة، إذ تُستنزف طاقة المربي في المهام الورقية بدل التفاعل البشري والتربوي، فيضعف الإبداع وتضمحلّ المبادرة، ويتراجع الأداء المدرسي في جوهره.
التفقد كسلطة متعددة الاختصاصات
إنّ تضارب الأدوار داخل المؤسسة التربوية جعل من المتفقد سلطة فوقية متعددة الاختصاصات، يراقب الوثائق الإدارية، ويُقيّم الأداء البيداغوجي، ويلاحظ التنظيم المدرسي، بل ويتدخل أحيانًا في مسائل تتعلّق بالإدارة المحلية والتسيير الداخلي.
بهذا التوسّع، يفقد التفقد معناه العلمي، ويتحوّل إلى جهاز رقابي شمولي يختزل كلّ أدوار المدرسة في شخص واحد، مما يُحدث خللًا هيكليًا في منظومة الإشراف.
فالمتفقد الحقيقي هو خبير بيداغوجي يرافق المعلمين في تطوير الكفايات التعليمية، وليس مراقبًا إداريًا يتفقد المعلّقات ويحصي الدفاتر.
وحين تختلط هذه الأدوار، تنشأ حالة من الارتباك المؤسسي، يفقد فيها الجميع وضوح المهام:
- المدير يتحول إلى منفّذ لتوصيات التفقد،
- المعلّم إلى كاتب إداري،
- والمتفقد إلى سلطة حكم لا مرشد تكويني.
نحو إعادة ضبط هندسة المسؤوليات داخل المدرسة
إنّ إصلاح هذه الوضعية يتطلّب إعادة هندسة العلاقة المهنية داخل المدرسة التونسية على أساس الفصل بين الأدوار وتكاملها:
- المعلم: مسؤول عن الفعل التربوي المباشر وتنمية الكفايات التعليمية.
- المدير: مسؤول عن التسيير الإداري والتنظيمي وضمان الظروف الملائمة للتدريس.
- المتفقد: مسؤول عن المرافقة البيداغوجية والتقييم التكويني والدعم المهني.
- القيم والعون الإداري: مسؤولان عن الإشراف الاجتماعي والتنظيمي والمساعدة اللوجستية.
وبذلك يُعاد للمدرسة توازنها الوظيفي، ويُستعاد للمعلم مقامه كفاعل تربوي مستقل، وللمتفقد دوره كمرجع تكويني لا سلطة رقابية.
خامسًا: الأثر النفسي والمهني لتقرير التفقد
من المفارقات العميقة في المنظومة التربوية التونسية أنّ أداة وُجدت أصلاً لتطوير الأداء المهني، تحوّلت إلى عامل ضغط نفسي واغتراب مهني. فـتقرير التفقد، في صيغته الحالية، لم يعد حافزًا على التكوين الذاتي، بل مصدرًا للتوتّر والقلق، يدفع المعلّم إلى الاشتغال من أجل إرضاء المتفقد لا من أجل بناء المتعلم.
لقد تغيّر الهدف من التفقد: من مرافقة تكوينية إلى امتحان بيروقراطي، ومن دعم الكفاءات إلى تقويم الانضباط.
التحضير التفقدي وثقافة “التمثيل التربوي”
تحوّلت “الحصة التفقدية” في المخيال المدرسي إلى حدث استثنائي يُعدّ له إعدادًا شكليًا متقنًا، أشبه بالبروفة المسرحية التي تُنَظَّم لإقناع المتفرّج أكثر من إقناع الذات.
في هذه اللحظة، يلبس المعلّم أفضل ما لديه من أدوات العرض: يُزيّن السبورة، يُراجع الأنشطة، يُهيّئ التلاميذ، ويضبط الزمن والوسائل بإتقان مسرحي، لا إيمان تربوي.
هكذا وُلدت في المدرسة ما يمكن تسميته بـ “ثقافة التمثيل التربوي”: حيث يغدو التعليم مشهدًا مُتقن الشكل فقير الجوهر، يهدف إلى ترك انطباع إيجابي لدى المتفقد، لا إلى تحقيق تعلم فعلي لدى المتعلمين.
وتلك الثقافة تُنتج ازدواجية خطيرة بين الممارسة الواقعية والصورة الرسمية، بين ما يُمارس فعلاً وما يُعرض للرقابة.
إنّها نوع من الانفصام التربوي، حيث يُفصل الخطاب عن الفعل، وتُختزل الجودة في مظاهرها الخارجية.
أثر التقرير على المناخ النفسي للمعلم
من منظور علم النفس المهني، تشكّل الممارسات الرقابية الصارمة دون مرافقة تكوينية عامل ضغط مزمن يؤدي إلى ما يُعرف في الأدبيات الحديثة بـ احتراق المعلّم المهني (Teacher Burnout).
فالخوف من الملاحظة، والقلق من التقييم، والإحساس الدائم بالمراقبة، تولّد لدى المعلّم مشاعر فقدان السيطرة (Loss of Control) وتآكل الدافعية الداخلية (Motivation intrinsèque).
يصبح المعلّم في هذه الحالة أسيرًا لدورة من القلق والتبرير:
- قلق قبل الزيارة خوفًا من النقائص.
- تبرير بعد الزيارة خشية سوء التأويل.
- ثم شعور بالإحباط لأنّ جهده الإبداعي لم يُقَدّر كما ينبغي.
وفي المدى البعيد، يؤدّي هذا المناخ إلى تفكّك الهوية المهنية للمربي، الذي يفقد إحساسه بالمعنى والجدوى. فالمهنة التي كانت رسالة، تتحوّل إلى وظيفة شكلية تُمارس بحذر أكثر مما تُمارس بشغف.
التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع العملي
من المفارقات الكبرى أنّ الخطاب الرسمي لوزارة التربية يرفع شعار “الجودة، والابتكار، والممارسة المنعكسة”، بينما يرسّخ تقرير التفقد — بصيغته الراهنة — منطقًا مضادًا تمامًا يقوم على الخضوع للنموذج الموحد، وإعادة إنتاج النمط، والانضباط الإجرائي.
وهكذا يتكرّس في الميدان ما يمكن تسميته بـ “نظام ازدواجي”:
- في الخطاب: نطالب بالتحرّر والإبداع.
- في الممارسة: نكافئ الانضباط والتقليد.
هذا الانفصام بين الرؤية والسياسة يخلق بيئة تربوية مضطربة، يفقد فيها المعلّم بوصلة الفعل التربوي: هل عليه أن يُبدع كما يُطلب منه، أم أن يلتزم بالنموذج الذي يُقيَّم عليه؟
وحين تتناقض الرسائل، تضيع الغاية التربوية، ويُختزل الجهد المهني في محاولة التوفيق بين ما يُقال وما يُراقَب.
أثر ذلك على التكوين الذاتي والدافعية المهنية
من المفترض أن يكون التقييم لحظة وعي نقدي وتغذية راجعة تفتح أفقًا للتطوير الذاتي. غير أنّ واقع التقرير الحالي جعل المعلم يعيش في مناخ من المراقبة لا من المواكبة، فضعفت لديه الرغبة في التجديد الذاتي والمساءلة الفكرية.
وحين يُقاس المعلم بمعايير ثابتة لا تُراعي الفوارق الشخصية أو السياقية، يصبح همه الأساسي “النجاة من الملاحظة” لا “تحسين الممارسة”.
يتراجع الإبداع لصالح الحذر، ويذوب الطموح المهني في روتين يومي يغيب عنه الإلهام التربوي.
في ظل هذا المناخ، يفقد التعليم روحه الإنسانية، ويتحوّل إلى منظومة انضباطية تُنتج الامتثال لا التطوير، وتُكافئ الولاء للنظام أكثر من الولاء للمتعلم.
نحو مقاربة إنسانية للتقييم
لا سبيل إلى إصلاح العلاقة النفسية بين المعلّم والتفقد إلا بإعادة تعريف وظيفة التقرير ضمن مقاربة إنسانية تكوينية، تجعل من المتفقد شريكًا في النمو المهني لا مصدرًا للقلق.
إنّ التفقد في جوهره يجب أن يقوم على:
- التشخيص البنّاء لا الحكم القاطع.
- الحوار التأملي لا الإملاء السلطوي.
- المرافقة المستمرة لا الزيارة المفاجئة.
- الاعتراف بالجهد الإنساني لا الاكتفاء بقياس النتيجة.
بهذه الروح وحدها يمكن أن تتحول المدرسة من فضاء رقابة إلى فضاء ثقة وتعلّم متبادل، حيث يشعر المعلّم أن تقييمه جزء من تكوينه، لا من محاسبته، وأنّ المتفقد ليس سلطة تعاقب بل سلطة ترافق.
لقد آن الأوان لتحرير التقرير التربوي من منطق المحاسبة واستعادته كأداة نموّ وتعلّم مهني. فالمعلم الذي يعمل في ظل الثقة ينتج إبداعًا، أما الذي يعمل في ظل الخوف فلا ينتج إلا الامتثال.
إنّ إصلاح التعليم لا يبدأ من البرامج ولا من الوثائق، بل من إعادة بناء الكرامة المهنية للمعلّم، لأنّ المعلم المطمئن هو وحده القادر على أن يربّي متعلمًا حرًّا، ناقدًا، وواثقًا من ذاته.
سادسًا: نحو إعادة بناء فلسفة التفقد التربوي
إنّ إصلاح منظومة التفقد التربوي في تونس لا يمكن أن يتحقّق عبر تنقيح تقارير شكلية أو تخفيف مؤشرات رقمية، لأنّ الخلل أعمق من أدوات التقييم.
إنّه خلل في الفلسفة التي تؤطّر التفقد ذاته: فلسفة ما زالت أسيرة المنطق الرقابي الذي يركّز على الضبط والمساءلة، بدل أن تقوم على مبدأ التكوين المستمر والمرافقة المهنية.
ولذلك، فإنّ أيّ إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من إعادة تعريف التفقد لا كجهاز مراقبة، بل كفضاء تفكير مشترك في جودة التعليم.
إنّ التفقد في جوهره ممارسة فكرية قبل أن يكون إجراء إداريًا، لأنه يعكس نظرتنا إلى العلاقة بين الدولة والمعلّم، بين السلطة والمعرفة، بين النظام والحرية.
فحين تُبنى المنظومة على الخوف، يكون التفقد أداة ضبط.
وحين تُبنى على الثقة، يصبح التفقد أداة بناء.
من المنطق الرقابي إلى المنطق التكويني
تاريخيًا، نشأ التفقد في ظل دولة مركزية تعتبر المدرسة جهازًا من أجهزتها الإدارية، فكان طبيعيًا أن يُصاغ بمنطق رقابي هرمي يضمن الانضباط ويمنع الانحراف.
لكن التعليم في القرن الحادي والعشرين لم يعد مجال تنفيذ الأوامر، بل مجال إنتاج المعرفة وإدارة الإبداع.
ولذلك لا يمكن أن تبقى آليات التفقد سجينة نموذج الانضباط البيروقراطي، لأنّ هذا النموذج لم يعد ملائمًا لمدرسة تتعامل مع الفكر والابتكار والتعلّم الذاتي.
التحوّل المطلوب إذن هو الانتقال من منطق المراقبة إلى منطق المواكبة، حيث يُنظر إلى المتفقد باعتباره موجهًا وشريكًا في التفكير، لا حَكمًا يصدر النقاط والأحكام.
وهذا لا يتحقق إلا بإعادة هندسة الدور التكويني للمتفقد على أسس تشاركية وتكوينية مستمرة.
من الإشراف الهرمي إلى الشراكة المهنية
المدرسة الحديثة تقوم على ثقافة الفريق لا على الهرمية.
فلا وجود لمتفقد يعلو على معلّم، بل هناك مجتمع مهني للتعلّم (Communauté d’apprentissage professionnel) يتعاون فيه الجميع على تطوير الأداء التربوي.
إنّ المتفقد في هذا التصور شريك خبير (Expert Partenaire)، يقدّم الدعم العلمي والنفسي والبيداغوجي، ويشارك في تحليل المشكلات وبناء الحلول، لا في إصدار التقارير الباردة.
إنّ الشراكة المهنية لا تنفي الرقابة، بل تجعلها رقابة تشاركية قائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة، حيث يُقاس النجاح بمدى تقدّم الفريق المدرسي لا بعدد النقاط في التقرير.
ولذلك وجب الانتقال من منطق “الإشراف من فوق” إلى “المرافقة من الداخل”، ومن سلطة الأمر إلى سلطة الحوار.
من التقييم العقابي إلى التقييم البنّاء
لا معنى لتقييم لا يُفضي إلى تعلم مهني، ولا جدوى من حكم لا يتبعه دعم.
فالتقييم في جوهره ليس لحظة إصدار حكم بل لحظة بناء وعي مهني، تتيح للمعلّم أن يرى ممارساته بعين جديدة، وأن يكتشف في ذاته طاقة التطوير.
التقرير البنّاء هو الذي يُبرز النقاط القوية، ويحلّل النقائص لا ليدينها بل ليفهم أسبابها، ويقترح حلولًا عملية للارتقاء بها.
إنّ التقييم البنّاء يحرّر العلاقة من ثنائية “الراصد والمتَفَقَّد” ويحوّلها إلى علاقة تفكير مشترك في السبل الممكنة لتحسين الجودة.
بهذا المعنى، يصبح التقرير وثيقة تكوين لا وثيقة مساءلة، ومحرّكًا للنمو المهني لا مقياسًا للامتثال الإداري.
ركائز الإصلاح الخمس
لتحقيق هذه النقلة المفاهيمية من التفقد السلطوي إلى التفقد البنّاء، لا بدّ من تأصيل الإصلاح في خمس ركائز عملية مترابطة:
- تحديث الإطار القانوني:
ينبغي مراجعة قانون 1964 بما يتناسب مع التحولات التربوية والتكنولوجية الراهنة، لتحديد مشمولات كلّ فاعل تربوي بوضوح، وحماية المعلّم من الأعباء الإدارية غير المشروعة، وضمان استقلالية الفعل البيداغوجي. - إشراك المربين في صياغة مؤشرات الأداء:
لأنّ المؤشرات الحقيقية لا تُفرض من الأعلى، بل تُبنى من الميدان. فالمعلّم أدرى من غيره بما يقيس جودة الممارسة الصفية، والمشاركة في صياغة هذه المعايير تُعزّز الشعور بالانتماء والمسؤولية المهنية. - اعتماد التقييم النوعي والتحليل الكيفي:
عبر أدوات جديدة مثل المقابلة التأملية، والملاحظة الميدانية التشاركية، وتحليل التعلمات، وملف الإنجاز المهني (Portfolio)، بما يسمح بقراءة عميقة للأداء لا سطحية رقمية له. - ربط التفقد بالتكوين المستمر في مسار مهني واحد:
فلا معنى لتفقد لا يُتبع بدورات دعم وتكوين فردي أو جماعي. يجب أن يصبح التفقد مرحلة ضمن دورة تعلم مهني مستمرة، يخرج منها المعلم بمهارات جديدة لا بمجرد نقاط. - تعزيز دور التفقد الميداني كمرافقة تربوية مستمرة:
من خلال زيارات متكررة ذات طابع بنائي، لا زيارات موسمية مفاجئة ذات طابع تأديبي. فالتفقد يجب أن يكون ممارسة دائمة للحوار والتغذية الراجعة، تعكس علاقة شراكة حقيقية بين المتفقد والمعلمين.
نحو فلسفة جديدة للتفقد
في ضوء هذه الركائز، يمكن القول إنّ التفقد التربوي لم يعد مجرّد أداة رقابة، بل أصبح حقلًا من التفكير المهني الجماعي، هدفه الأسمى بناء ثقافة الجودة لا فرضها.
فالفلسفة الجديدة للتفقد تقوم على ثلاثة مبادئ كبرى:
- الإنسان محور العملية التربوية: المعلّم قبل الوثيقة.
- التعلّم الدائم مبدأ مهني: التفقد وسيلة لتكوين الجميع.
- الثقة قاعدة الإصلاح: لا جودة دون أمن مهني ونفسي.
إنّنا اليوم بحاجة إلى متفقد يُفكّر مع المعلّم، لا مكانه؛ يُرافقه في رحلته المهنية لا في خطئه فقط؛ ويؤمن أنّ الإصلاح لا يُفرض من الأعلى بل يُبنى بالحوار من القاعدة.
بهذا المعنى، يصبح التفقد في المدرسة التونسية فعلًا تربويًا ذا روح إنسانية، يُحرّر المعلّم من الخوف، ويعيد للتعليم رسالته الحضارية القائمة على المعرفة، الحرية، والمسؤولية المشتركة.
الخاتمة
إنّ تقرير التفقد في صيغته الراهنة لا يعبّر عن روح المدرسة التونسية التي حلم بها رواد الإصلاح التربوي منذ الاستقلال، تلك المدرسة التي أرادوا لها أن تكون فضاء حرية وفكر ومسؤولية جماعية، لا مجرّد جهاز إداري متخشّب يعيد إنتاج البيروقراطية القديمة.
لقد اختُزل الفعل التربوي في معايير شكلية وإجراءات إدارية، وذُوّب المعلّم داخل منظومة تفقد تُقيم الأداء بمعيار الطاعة لا بمعيار الإبداع، وتُكافئ الامتثال بدل الكفاءة، وكأنّ الرسالة التربوية لم تعد رسالة تنوير، بل مجرّد امتثال للنماذج والأوامر.
إنّ إصلاح التعليم لا يبدأ من تغيير البرامج أو الكتب أو الوسائل، بل من إعادة الاعتبار للإنسان المربي؛ ذاك الذي يصوغ الوعي ويمنح المعرفة معناها.
فحين يتحرّر التفقد من نزعة السيطرة، ويستعيد جوهره كمرافقة فكرية وتكوينية، عندها فقط نستطيع الحديث عن مدرسة تُنصت إلى معلميها، وتُقيم الإصلاح من الداخل لا من فوق.
ولذلك فإنّ إعادة بناء منظومة التفقد ليست مجرّد ضرورة إدارية، بل هي شرط حضاري لإعادة الثقة في المدرسة التونسية.
فالمدرسة ليست بناية ولا مناهج، بل هي علاقة إنسانية تُبنى على الثقة والاحترام والاعتراف المتبادل.
والمعلم ليس موضوع تفقد، بل شريك في بناء الوعي الوطني والإنساني، ومؤتمن على ضمير الأمة ومستقبلها.
وحين يدرك المتفقد أنّ مهمته ليست أن يراقب المعلّم بل أن يُصغي إليه، ولا أن يحاسبه بل أن يُرافقه، يتحوّل التفقد من سلطة إلى شراكة، ومن رقابة إلى ثقافة، ومن ورق إلى وعي.
إنّ التفقد التربوي حين يتحرّر من طابعه الإداري يصبح فنًّا تربويًا نبيلًا، يُعيد للتعليم روحه، وللمربي هيبته، وللمتعلم متعة الاكتشاف والمعرفة.
وحينها فقط تستعيد المدرسة التونسية رسالتها التاريخية: أن تكون منارة عقلٍ، وضمير وطنٍ، ومصنع أجيالٍ تؤمن بأنّ الحرية والتعلّم وجهان لجوهرٍ واحد.
هوامش المقال:
التحليل القانوني للقاعدة: “المسؤوليات تُحدَّد بالنصّ لا بالعرف الإداري”
أولاً: الأساس التشريعي في القانون التونسي
ينصّ القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في عدة فصول على ما يؤكّد هذه القاعدة:
- الفصل 2: “يخضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لأحكام هذا القانون الأساسي العام وللأحكام الخاصة المطبقة على سلكهم أو رتبتهم.” هذا الفصل يؤسس لمبدأ جوهري هو أن الواجبات والحقوق المهنية تُحدَّد حصريًا بمقتضى نصوص قانونية أو نظامية، أي الأوامر والمراسيم والمناشير التي تصدر في إطارها. فلا يمكن لأي سلطة إدارية أن تضيف واجبات أو صلاحيات لم تُحدَّد تشريعيًا.
- الفصل 6 من القانون ذاته: “يُمارس الأعوان العموميون مهامهم في حدود النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.” هذا الفصل يُغلق الباب أمام الاجتهاد الإداري المنفلت أو فرض مسؤوليات جديدة خارج النصوص النافذة، ويؤكد أن الموظف لا يُسأل إلا في حدود ما ألزمه به القانون.
وبالتالي، فإنّ أي عمل أو تقييم يُبنى على واجبات لم ترد في هذه النصوص يُعدّ خارجًا عن إطار المشروعية، مما يجعله عرضة للإبطال أمام القضاء الإداري.
ثانيًا: مبدأ المشروعية في الوظيفة العمومية
يُعدّ مبدأ المشروعية (Principe de légalité) حجر الأساس في القانون الإداري التونسي، وهو يقضي بأنّ كل تصرف إداري — مهما كانت درجته — يجب أن يستند إلى نصّ قانوني نافذ وصريح.
ويُترجم هذا المبدأ في الوظيفة العمومية من خلال قاعدتين فرعيتين:
- قاعدة تقييد السلطة بالنص:
الإدارة لا تملك من السلطات إلا ما خوّله لها القانون صراحة. فليس لها أن تُنشئ التزامات جديدة أو تفرض واجبات إضافية على الأعوان العموميين دون سند قانوني. - قاعدة الأمن القانوني للموظف:
الموظف لا يُسأل إلا في نطاق ما هو مكلّف به قانونًا. فتكليفه بمهام لم يرد ذكرها في النصوص، ثم تقييمه أو محاسبته على أساسها، يمسّ بمبدأ الأمن القانوني ويُعتبر تعديًا على الحقوق الإدارية.
وقد رسّخ القضاء الإداري التونسي هذا المبدأ في عدة أحكام، مؤكدًا أن الإدارة تتجاوز سلطتها عندما تُنشئ التزامات مهنية جديدة دون نصّ صريح، وأنّ القرارات الناتجة عن هذا التجاوز قابلة للإبطال.
ثالثًا: مفهوم “تجاوز السلطة” (Excès de pouvoir)
يقع تجاوز السلطة عندما تصدر الإدارة قرارًا أو إجراءً دون سند قانوني أو خارج حدود صلاحياتها.
وفي سياقنا، إذا قام المتفقد بإدراج معايير تقييم تتعلق بمهام لم تُسند قانونًا إلى المعلم (مثل كراسات القسم، المعلّقات، أو الحراسة)، فإنّ فعله يُعتبر:
- تجاوزًا للسلطة النوعية: لأنه مارس صلاحية لم تُمنح له بموجب نصّ.
- تجاوزًا للسلطة الموضوعية: لأنه وسّع مجال التقييم إلى أعمال ليست من مشمولات المعلّم.
وبحسب فقه القضاء الإداري، فإنّ هذا النوع من التجاوز يُعرّض القرار الإداري (في هذه الحالة تقرير التفقد) إلى الإبطال القضائي إذا ثبت أنّه بُني على معايير غير قانونية.
رابعًا: التطبيق على وضعية المعلم
استنادًا إلى ما سبق، فإنّ المعلم الذي يُقيَّم في تقرير التفقد على مهام لم يُلزم بها القانون (قانون 1964 أو النصوص الترتيبية اللاحقة) يمكنه — من حيث المبدأ — الاعتراض على التقرير إداريًا، أو الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية باعتباره:
- قرارًا إداريًا مشوبًا بتجاوز السلطة (Dépassement de compétence)،
- وقرارًا منعدم السند القانوني (Décision sans base légale).
ذلك لأنّ التقييم لا يكتسب المشروعية إلا إذا استند إلى نصّ واضح يحدّد بدقة ما يُنتظر من الموظف.
وكل تقييم يتجاوز هذا الإطار يُعتبر غير مشروع، ويفتح إمكانية المساءلة القانونية للسلطة الإدارية ذاتها.
خامسًا: الخلاصة القانونية
بناءً على القانون العام للوظيفة العمومية التونسية ومبادئ المشروعية الإدارية يمكن القول إنّ:
القاعدة العامة تقضي بأنّ المسؤوليات تُحدَّد بالنصّ لا بالعرف الإداري،
وأيّ تقييم يُبنى على واجبات لم تُقرّ تشريعيًا يُعدّ تجاوزًا للسلطة ومساسًا بمبدأ المشروعية،
مما يجعل التقرير أو القرار الناتج عنه قابلاً للإبطال أمام القضاء الإداري،
ويحمّل صاحبه (سواء كان متفقدًا أو مديرًا) المسؤولية الإدارية عن الخطأ في استعمال السلطة.
الأستاذ: عماد إيلاهي





