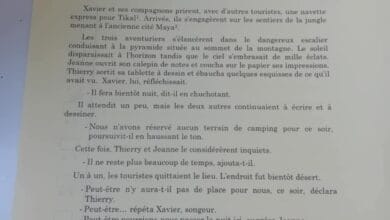تحطيم أصنام التعليم في تونس: نحو نهضة تربوية حقيقية
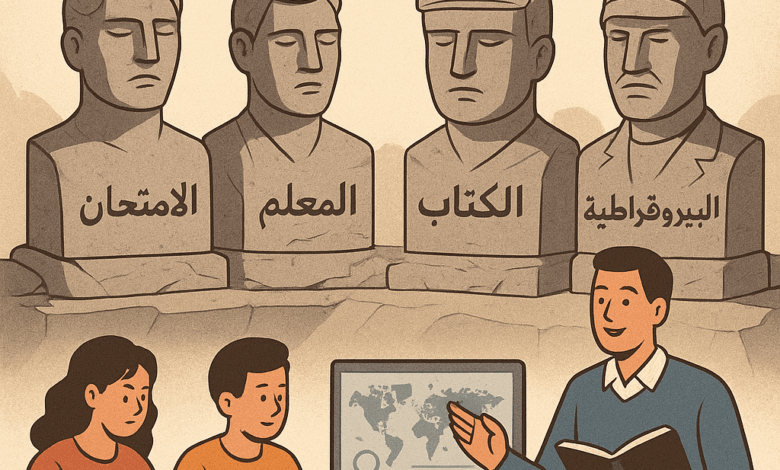
منذ الاستقلال إلى اليوم، ظلّ التعليم في تونس محور السياسات العامة وواجهة المشاريع الوطنية، لكن رغم الإصلاحات المتتالية، لم ننجح في تحقيق التحول النوعي المنشود. فما زال المتعلم يعاني من نظام جامد يرهقه، والمعلم يواجه منظومة بيروقراطية تُكبّله، والمدرسة تتحول شيئًا فشيئًا إلى فضاء للعقاب أكثر من كونها بيئةً للابتكار والنمو.
ولعلّ السبب الجوهري لهذا الجمود هو هيمنة “أصنام التعليم”، أي مجموعة من الأفكار والممارسات التي اكتسبت بمرور الزمن طابع القداسة، فأصبحت تعيق كل محاولة جادة للتجديد.
1. صنم الامتحان: من التقييم إلى التعذيب المعرفي
منذ عقودٍ، تمكّن الامتحان من أن يتحول في تونس من وسيلة بيداغوجية إلى غاية مقدسة. لم يعد يُنظر إليه كأداة لتقويم التعلم وتحسينه، بل كـ”محكمة نهائية” تقرر مصير المتعلم، وتختزل سنوات من الجهد في رقمٍ جافٍّ على ورقة.
تحولت المدرسة التونسية إلى فضاء يعيش في ظلال الخوف من التقييم، لا في أنوار المعرفة. فكل ما يُدرّس وكل ما يُراجع وكل ما يُقاس يدور في فلك الامتحان، حتى صار المتعلم يعيش موسماً دائماً من التوتر، يتعلم ليجتاز لا ليكتشف، ويحفظ ليُرضي لا ليبدع.
أ- الامتحان كمحرّك زائف للتعلم
المنظومة التربوية في تونس تبني تقويمها على مبدأ الترتيب والفرز، لا على مبدأ النمو والتطور. فالغاية من الامتحان لم تعد فهم ما اكتسبه المتعلم، بل معرفة موقعه من الآخرين.
يتعلم التلميذ منذ سنواته الأولى أن الغاية من المدرسة هي “الحصول على عدد”، لا بناء مشروع ذاتي أو تنمية مهارة. لذلك نراه يقيس قيمته الذاتية بالعلامة لا بما يفكر فيه أو يصنعه.
كم من متعلمٍ متفوقٍ بالأرقام يعجز عن التعبير عن نفسه، وكم من آخرٍ صُنّف “ضعيفًا” لأنه لا يحسن الحفظ، بينما يملك خيالاً خصباً وقدرة على الابتكار.
ب- صناعة الخوف بدل تنمية الفضول
من المفترض أن يكون التقييم لحظة تأمل في المسار، لكن الامتحان التونسي صار أداة ترهيب. تُبنى حوله طقوس كاملة من القلق والضغط العائلي والاجتماعي.
يُهدَّد التلميذ من صغره بأن “المستقبل مرهون بالعدد”، فيعيش تجربة تربوية قوامها الخوف من الفشل لا حب النجاح.
وهكذا يُقتل الفضول في المهد، ويُزرع مكانه هاجس الامتحان. يتحول التلميذ من باحث عن المعرفة إلى “ناجٍ من العقوبة”.
حتى في الإجازات، يعيش التلاميذ في قلق “الدروس الخصوصية” و”التحضيرات المبكرة”، كأن التعلم أصبح عملاً شاقاً لا متعة فيه.
ج- المعلم رهينة المنظومة الامتحانية
المعلم بدوره أصبح أسير هذا الصنم. فبدل أن يبدع في طرق تدريسه، صار يوجّه كل جهده إلى إعداد المتعلمين لاجتياز الامتحان.
يقلّص من الأنشطة التفاعلية، ويهمل النقاش الحر، ويختزل التعلم في “ما سيُسأل عنه في الاختبار”. بل أحياناً يُقاس أداء المعلم نفسه بمدى نجاح تلاميذه في الامتحان، لا بمدى تطورهم الحقيقي في التفكير والتحليل.
وهكذا يُفرض على الجميع منطق رقميّ ضيق يُخفي وراءه أزمةً أعمق: المدرسة لا تُنتج إنسانًا مفكراً، بل متعلماً مروضاً على الطاعة.
د- الأعداد وهمُ الموضوعية
يرى كثيرون أن العلامة هي المقياس العادل للكفاءة، لكنها في الواقع أداة شكلية تُخفي تفاوتات عميقة.
فالأعداد لا تقيس الجهد ولا الإرادة ولا الإبداع، بل تختزل كل شيء في لحظة امتحان واحدة، قد ينجح فيها الحافظ ويُقصى المفكر.
تلميذ يملك قدرة على التحليل لكنه بطيء في الكتابة، يُعاقب بعلامة ضعيفة، بينما آخر يكرر الجمل المحفوظة يحظى بالتفوق.
بهذا المعنى، يتحول الامتحان من مرآة للتعلم إلى جدارٍ يفصل بين المدرسة والحياة.
في كثير من الأحيان، يُثبت الواقع أن من “فشلوا” في الامتحانات، نجحوا لاحقاً في مجالات الفن، والريادة، والابتكار، لأنهم تعلّموا خارج حدود الورقة والقلم.
هـ- الامتحان ومفارقة العدالة الاجتماعية
في تونس، أصبح الامتحان أيضاً مرآة لغياب المساواة.
فمن يملك المال يستطيع تعويض ضعف المدرسة بدروس خصوصية مكثفة، بينما يواجه المتعلم من الأحياء الفقيرة امتحانين في آنٍ واحد: امتحان المادة وامتحان الفقر.
أصبح النجاح في الامتحانات في كثير من الأحيان مرهونًا بالقدرة على الدفع، لا بالجهد الفردي. وهكذا تحولت المنظومة التربوية من أداة للترقي الاجتماعي إلى أداة لإعادة إنتاج الفوارق.
و- نحو تقييم إنساني بديل
تحطيم صنم الامتحان لا يعني إلغاء التقويم، بل إعادة تعريفه.
ينبغي أن ننتقل من التقييم القائم على “النتيجة” إلى التقييم القائم على “المسار”، بحيث يُتابع المتعلم في تطوره عبر ملفات إنجاز ومشاريع بحث وملاحظات سلوكية.
يمكن أن يصبح الامتحان مجرد محطة ضمن مسار تعلمي طويل، لا سيفًا مسلطًا على الرؤوس.
في بعض الدول المتقدمة، يُقوَّم التلميذ من خلال قدرته على التعاون، والتفكير النقدي، وحل المشكلات الواقعية، لا عبر اختبارات الحفظ.
ذلك ما نحتاجه في تونس: ثورة تربوية تنقلنا من ثقافة الخوف إلى ثقافة التعلم الذاتي.
ز- التعليم من أجل الحياة لا من أجل الورقة
حين يتحرر التعليم من عبودية الامتحان، ستستعيد المدرسة التونسية معناها الإنساني: فضاء لتربية الفكر لا لتصفية الحسابات.
سيصبح السؤال الأهم: “ماذا تعلمت؟” بدل “كم نلت؟”.
وسندرك أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بالأعداد، بل بقدرة المتعلم على أن يعيش حياة منتجة، أخلاقية، مبدعة.
حينها فقط، يمكن القول إننا بدأنا فعلاً في تحطيم صنم الامتحان، أول الأصنام التي كبّلت منظومتنا التربوية، وأبعدتنا عن جوهر التعليم بوصفه رحلة نحو الوعي لا سباقًا نحو المعدلات.
2. صنم السلطة التربوية: المعلم بين القداسة والجمود
من بين أخطر الأصنام التي كبّلت التعليم في تونس، صنم السلطة التربوية، أو بالأحرى القداسة المصطنعة للمعلم، التي جعلت من الفعل التربوي علاقة عمودية بين من “يعلم” ومن “يتعلم”، بدل أن تكون علاقة أفقية قائمة على الحوار والنمو المتبادل.
فقد ورثت المدرسة التونسية، منذ نشأتها، نموذجًا سلطويًا متأثرًا بالثقافة الإدارية والسياسية التي سادت في فترات ما بعد الاستقلال، حيث كانت المدرسة أداة لبناء المواطن المطيع، لا الفرد الحرّ. وهكذا تشكّل وعيٌ جمعي يرى في المعلم “السلطة داخل الفصل” لا “القائد التربوي”.
أ- المعلم كرمز للقداسة الاجتماعية
يُنظر إلى المعلم في الذاكرة الشعبية على أنه صاحب رسالة نبيلة، “العارف” و“القدوة”، وهو تقدير مستحق في جوهره، لكنه تحوّل بمرور الزمن إلى قداسة مغلقة.
ففي عديد الفصول الدراسية، لا يُسمح للتلميذ بالاعتراض أو حتى السؤال خارج ما هو “مقرر”. وكل محاولة للنقاش تُعدّ “قلة أدب” أو “تجاوزًا للحدود”.
بهذه الطريقة، تُقتل روح النقد في مهدها، ويُربّى المتعلم على الخضوع بدل الجرأة الفكرية.
في بعض المدارس، يظل المعلم “الكل في الكل”، يقرر، ويقيم، ويعاقب، دون أي مساحة للتفاوض أو المشاركة. هذه السلطة المبالغ فيها تجعل المدرسة صورة مصغرة عن نظام بيروقراطي مغلق، لا عن مجتمع ديمقراطي ناشئ.
ب- من السلطة المعرفية إلى السلطة الانفعالية
ليست السلطة التربوية فقط سلطة معرفة، بل كثيرًا ما تتحول إلى سلطة انفعالية أو نفسية.
فالمعلم الذي لم يتلق تكوينًا في التربية الحديثة، يجد نفسه مضطرًا لتثبيت هيبته بالصوت المرتفع والعقوبة، لا بالحوار والإقناع.
ويُقابل هذا الخضوع بخضوع مضادّ: التلميذ لا يحترم المعلم عن قناعة، بل يطيعه خوفًا، فإذا غاب الرقيب، غابت الجدية.
بهذا المعنى، لا يتحقق الانضباط الحقيقي، بل يُصنع “انضباط وهمي” سرعان ما ينهار خارج أسوار المدرسة.
في الواقع، كثير من المشكلات السلوكية التي يشكو منها المعلمون اليوم هي ثمرة مباشرة لهذا النمط التسلطي الذي لم يعد صالحًا في زمن وُلد فيه التلميذ وفي يده الهاتف الذكي، يتعامل مع المعلومة بحرية لا تستطيع المدرسة ضبطها.
ج- المعلم ضحية سلطته القديمة
المفارقة أن المعلم نفسه ضحية لهذه السلطة التي يتشبث بها.
ففي الوقت الذي يُعامل فيه داخل الفصل كـ”صاحب كلمة نهائية”، يُعامل خارجه كموظف بسيط ينفذ الأوامر دون أن يُستشار.
قرارات الإصلاح التربوي تُتخذ من فوق، دون إشراك المعلمين في صياغة المناهج أو السياسات.
تُفرض عليه وثائق وبرامج ومذكرات جاهزة، ثم يُحاسب على نتائجها.
هكذا يعيش المعلم انقسامًا مؤلمًا: قويّ داخل القسم، ضعيف خارجه؛ مسموع داخل الجدران، منسيّ في مراكز القرار.
إنها سلطة شكلية، تُغطي هشاشة حقيقية، وتجعل من المربي طرفًا مأزوماً بين الامتثال والإرهاق.
د- آثار هذا الصنم على المتعلم
في ظل هذه السلطة المغلقة، يتحول المتعلم إلى متلقٍّ سلبي، لا يملك زمام تعلمه.
تغيب روح المبادرة، وتنطفئ شرارة الاكتشاف. يتعلم كيف “يرضي” المعلم، لا كيف “يفكر”.
كثير من التلاميذ في تونس، خاصة في المراحل الإعدادية والثانوية، يعانون من الخوف من المشاركة، لأنهم تعرّضوا سابقًا للتوبيخ أو السخرية عند أول خطأ.
فتتشكل لديهم قناعة أن الصمت هو الأمان، وأن الكلام خطر. وهكذا يُقتل الإبداع، وتُختزل العملية التربوية في التكرار والتقليد.
هـ- أمثلة من الواقع التونسي
في عديد المدارس، ما زال الحوار البيداغوجي بين المعلم والمتعلم منعدماً.
مثلًا، في بعض فصول اللغة العربية، يُلقّن التلميذ النصوص دون أن يُطلب منه تحليلها أو مناقشتها، فيتحول النص الأدبي إلى مادة جافة.
وفي العلوم، يندر أن يُطلب من المتعلم إجراء تجربة أو فرضية شخصية، لأن الوقت “لا يسمح”.
الامتحان يقود الدرس، والبرنامج يقود المعلم، والمعلم يقود الصمت.
هكذا يتكرّس نظام طبقي داخل المدرسة، حيث المعلم يمثل السلطة، والمتعلم يمثل الخضوع، والوزارة تمثل القيد الذي يربط الاثنين معًا.
و- الطريق إلى كسر الصنم: المعلم شريك لا متسلط
تحطيم صنم السلطة التربوية لا يعني المسّ بمكانة المعلم، بل تحريره من دور المتسلط ليصبح قائدًا تربويًا وشريكًا في بناء الوعي.
يبدأ ذلك بإعادة تكوين المعلمين على المقاربات الحديثة: بيداغوجيا المشروع، التعلم القائم على الكفايات، التعلم التعاوني، والتربية على التفكير النقدي.
على المعلم أن ينتقل من موقع “العارف” إلى موقع “الميسر”، وأن يُدرك أن سلطته الحقيقية لا تُستمد من الصراخ أو السيطرة، بل من الإقناع والقدرة على خلق بيئة تعلمية حية.
كما يجب أن تستعيد الدولة احترامها له، عبر تمكينه من اتخاذ القرار التربوي، لا تحويله إلى منفذ روتيني للمذكرات.
ز- نحو عقد تربوي جديد
إنّ التربية الحديثة لم تعد تقوم على الخوف، بل على الثقة.
لا بد من إعادة صياغة علاقة المعلم بالمتعلمين على أساس المشاركة والتعاون.
فالمعلم في القرن الحادي والعشرين هو قائد رحلة فكرية، لا حارس نظام.
حين يتحول الفصل من فضاء للإملاء إلى فضاء للحوار، ومن منصة للسلطة إلى ورشة للخلق، سنبدأ في بناء جيل جديد من التونسيين: متعلمين أحرارًا، لا مكررين لما يُقال لهم.
إنّ تحطيم صنم السلطة التربوية هو تحطيم لصورة التعليم القديم الذي بنى الذاكرة وأهمل الوعي، وبداية لنهضةٍ تربوية تضع الإنسان في قلب الفعل التعليمي، لا على هامشه.
3. صنم الكتاب المدرسي: المعرفة في سجن الورق
منذ عقود، ظلّ الكتاب المدرسي في تونس هو المرجع المقدّس في العملية التعليمية، لا يُناقش ولا يُمسّ. كل ما فيه يُعتبر “الصحيح” و”الكامل”، وما عداه يُعدّ تجاوزًا أو تشويشًا على “النظام”. لكن هذا الاعتقاد جعل المدرسة التونسية حبيسة الورق، لا ترى من المعرفة إلا ما تسجله المطبعة، ولا تسمح للمتعلم بأن يُطلّ برأسه خارج أسوار النص الرسمي.
في زمن الانفجار المعرفي والتحوّل الرقمي، لم يعد الكتاب المدرسي كافيًا لتكوين المتعلم في عالم متغير يتطلب مهارات التفكير والتحليل والنقد. فالمعرفة اليوم لا تسكن بين دفّتين، بل تتحرك وتتجدد في الفضاء الرقمي، عبر مقاطع الفيديو التعليمية، والدورات المفتوحة، والمصادر التفاعلية التي تتيح فهماً حيّاً للظواهر والعلوم. غير أنّ المدرسة التونسية ما زالت تنظر إلى هذه الوسائل بعين الريبة، وكأنها خطر على الانضباط أو تهديد لسلطة المعلم، فتغلق أبوابها أمام الثورة الرقمية وتكتفي بإعادة إنتاج القديم.
لقد أفرز هذا الجمود تلميذًا “حافظًا” لا “باحثًا”، ينتظر المعلومة بدل أن يصنعها، ويتعامل مع المعرفة بوصفها “حقيقة جاهزة” لا مجال لمساءلتها. لذلك، صار من الضروري تحطيم هذا الصنم الذي جعل الكتاب المدرسي سجنًا للمعرفة، لا بوابةً لها.
تحرير المنظومة من هيمنة الكتاب يعني جعل الفصل الدراسي فضاء مفتوحًا للتجريب والاكتشاف، حيث يُستخدم الكتاب كمنطلق، لا كحدّ. كما يعني تمكين المعلمين من أدوات التكنولوجيا وتدريبهم على تصميم أنشطة رقمية تربط الدرس بالحياة الواقعية.
ولنا في الواقع التونسي أمثلة حيّة على هذا التحول حين تتاح له الفرصة: بعض المدارس النموذجية في سوسة وصفاقس بدأت توظّف المنصات التعليمية مثل Google Classroom وMicrosoft Teams، وسمحت للتلاميذ بإنجاز بحوث مصوّرة ومشاريع رقمية حول مواضيع من صميم الواقع البيئي والاجتماعي. تلك التجارب الصغيرة أثبتت أن المتعلم، حين يُمنح الحرية والثقة، يتجاوز حدود الكتاب ويصبح شريكًا في إنتاج المعرفة.
إنّ كسر صنم الكتاب المدرسي هو الخطوة الأولى نحو تعليم حيّ، متجدّد، يعلّم التفكير لا التكرار، ويجعل من المتعلم مواطنًا رقميًا ناقدًا، لا نسخة ورقية مكررة من جيل سابق.
4. صنم البيروقراطية: الإدارة ضد الإصلاح
من أخطر ما يعوق التعليم في تونس أنّ المنظومة التربوية تُدار بعقلٍ بيروقراطيٍّ متضخّم، يرى في الورق ضمانةً للجودة، وفي المراسلات معيارًا للنجاح، وفي التوقيعات غاية الإصلاح. كل شيء يجب أن يمر عبر “المسالك الإدارية” التي تستهلك الوقت والجهد، حتى غدت المدرسة جهازًا تنفيذياً مثقلاً بالإجراءات، لا فضاءً للإبداع أو التجديد.
المدير منشغل بتجميع الأرقام وملء الجداول والردّ على المراسلات التي تمطرها الوزارة بلا انقطاع، والمتفقد غارق في تقارير التقييم أكثر مما هو حاضر في الفعل التربوي، والإدارة المركزية منشغلة بإصدار المذكرات والتعليمات التي تُنزل من فوق دون تشاور أو اختبار ميداني. وبين كل هذه الطبقات الإدارية، يُدفن المعلم، ويُغتال الحلم الإصلاحي قبل أن يولد.
لقد أصبحت البيروقراطية في التعليم مثل دوامة تدور حول نفسها، تستهلك الطاقة دون أن تُنتج قيمة. فالمدارس تشتغل بمنطق الالتزام بالشكليات لا بجوهر العملية التعليمية، ويُقاس “النجاح الإداري” بعدد الملفات المنجزة لا بعدد المتعلمين الذين تغيّر وعيهم. وكثيرًا ما يُعاقب المعلم المبتكر لأنه خرج عن “النصّ الإداري”، بينما يُكافأ من يُحسن الانصياع.
ولنا في الواقع شواهد كثيرة: معلمون طوّروا مشاريع رقمية أو تربوية رائدة اصطدموا بالرفض لأنها لم تكن “مطابقة للنموذج”، أو لأنها لم تمرّ عبر السلم الإداري المطلوب. مدارس حاولت إقامة شراكات مع المجتمع المدني أو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، فقوبلت بالتحفظ لأن “الإجراء غير منصوص عليه”. كل ذلك يبرهن أنّ الإصلاح في تونس لا يفشل بسبب نقص الأفكار، بل بسبب جدار البيروقراطية الذي يخنقها.
تحطيم صنم البيروقراطية يعني قلب الهرم الإداري رأسًا على عقب: أن تُمنح السلطة للمدرسة وللمعلمين بوصفهم الفاعلين الحقيقيين، وأن تُبنى القرارات على قاعدة المشاركة والتجريب لا على التعليمات الجاهزة. كما يعني رقمنة الإدارة التربوية لتتحول من سلطة ورقية إلى منصة دعم فعلي للمبادرات الميدانية.
حينها فقط يمكن أن ننتقل من “مدرسة الطاعة” إلى “مدرسة الفعل”، ومن “وزارة المذكرات” إلى “وزارة الأفكار”، لأن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يولد من رحم إدارة تُقيس الحياة بالملفات، بل من إرادة حرة تؤمن بأن التعليم فعل تحرّر لا طاعة.
5. صنم المناهج القديمة: تعليم بلا حياة
لا يزال التعليم في تونس أسيرَ مناهج وُضعت لعصرٍ مضى، تُعيد إنتاج نفسها كل عقد تحت أسماء جديدة، لكنها تحتفظ بالجوهر ذاته: التلقين، والحفظ، والتقييم بالأعداد. ما زال المتعلم يدرّس كما كان يفعل جيل الستينات، في عالم تغيّر فيه كل شيء إلا المدرسة. فالمناهج الحالية تُقدّم معارف جاهزة، مجزأة، لا تمتّ بصلة إلى الحياة الواقعية للمتعلمين، ولا تُكسبهم أدوات التفكير النقدي أو مهارات القرن الواحد والعشرين.
يدرس التلميذ نصوصًا أدبية لا تلامس قضاياه، ويحلّ مسائل رياضية دون أن يفهم أين يمكن أن يطبقها، ويحفظ تواريخ ومعارك لا يعرف مغزاها في بناء وعيه الوطني أو الإنساني. المدرسة تُدرّب الذاكرة، لا العقل. وهكذا يصبح التعلم عملاً ميكانيكيًا خاليًا من الدهشة، فينفصل المتعلم عن المعرفة كما ينفصل النبات عن التربة.
إنّ نتيجة هذا الجمود واضحة في الميدان: متعلمون يفشلون في التواصل، في التفكير النقدي، في العمل الجماعي، وفي تحويل المعلومة إلى مهارة. جامعات تخرّج آلاف العاطلين لأن ما درّسوه لا يلتقي مع حاجات سوق العمل، ومؤسسات تربوية تستنزف الزمن في مراجعة نفس المحتويات القديمة بدل أن تطرح السؤال الجوهري: لماذا نتعلم؟ ولأجل ماذا؟
إنّ إصلاح المناهج لا يعني فقط تغيير الكتب أو تحديث البرامج شكليًا، بل يقتضي ثورة فكرية في فلسفة التعليم نفسها. علينا أن ننتقل من منطق “المعارف الجاهزة” إلى منطق “الكفاءات الحيّة”، ومن الحشو إلى الفهم، ومن التكرار إلى الإبداع. يجب أن يتحول الفصل الدراسي إلى ورشة حياة، تُدمج فيها القضايا المجتمعية، والبيئية، والثقافية، حتى يشعر المتعلم أنّ ما يتعلمه يُغيّر واقعه.
وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من بعض التجارب التربوية التونسية الناجحة حين مُنحت حرية التجريب: مدارس أدخلت التعلم القائم على المشاريع (Project-Based Learning)، ومؤسسات اعتمدت المقاربة بالكفايات الحقيقية وربطت الدروس بمشكلات المجتمع المحلي، فكانت النتائج مدهشة في تنمية التفكير والإبداع والمسؤولية لدى التلاميذ.
إنّ تحطيم صنم المناهج القديمة يعني أن نُعيد للتعليم روحه: أن نعلّم أبناءنا كيف يعيشون لا كيف يكررون، أن نغرس فيهم حبّ التساؤل لا رهبة الإجابة، وأن نجعل المدرسة فضاءً للحياة لا متحفًا للكتب. حينها فقط يمكن أن يُولد جيلٌ يعرف كيف يصنع مستقبله بدل أن يحفظ ماضيه.
الخاتمة:
نحو ثورة فكرية تحرر المدرسة التونسية من أوثانها
إنّ الحديث عن “تحطيم أصنام التعليم في تونس” ليس شعارًا إصلاحيًا عابرًا، بل هو دعوة إلى ثورة فكرية هادئة تعيد للمدرسة معناها الإنساني. لقد آن الأوان لأن نكسر كل قيدٍ يجعل من التعليم طقسًا شكليًا بدل أن يكون فعلًا للتحرر والنهضة. فالامتحان يجب أن يعود إلى وظيفته الأصيلة: التقييم من أجل التعلم، لا التعذيب من أجل الأعداد. والمعلم ينبغي أن يتحول من سلطة إلى شريك في بناء الوعي، والكتاب من مرجع جامد إلى نافذة على العالم، والإدارة من جهاز مراقبة إلى قوة دعم وتمكين، والمناهج من نصوص متحجرة إلى تجارب حياة تنبض بالواقع والإبداع.
إنّ إصلاح التعليم في تونس ليس مجرد مراجعة تقنية، بل هو مشروع وطني يستهدف الإنسان ذاته: أن نفكر بطريقة جديدة، أن نربّي على الحرية لا على الطاعة، وعلى النقد لا على الحفظ، وعلى الإبداع لا على التكرار. فحين تتحرر المدرسة من أصنامها، يتحرر المجتمع من جمود تفكيره، وتصبح التربية الطريق الحقيقي إلى النهضة.
لقد أثبت التاريخ أن كل أمة نهضت، إنما بدأت من الفصل الدراسي. وحين نمنح أبناءنا مدرسة تُعلّمهم الحياة، سنستعيد تونس الحقيقية: تونس العقل، والقيم، والإرادة.
المراجع:
- وزارة التربية التونسية، تقرير الإصلاح التربوي الوطني، 2016.
- اليونسكو، مستقبل التعليم 2050: إعادة تصور مجتمعات التعلم، باريس، 2021.
- Fullan, M. (2020). The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press.
- OECD (2019). Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass.
- اليعقوبي، لسعد. التعليم في تونس بين الإصلاح المؤجل والواقع المتجمد، دار سراس، تونس، 2018.
- Delors, J. (1996). Learning: The Treasure Within. UNESCO Report to the International Commission on Education for the Twenty-first Century.